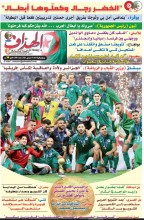-
آخر الأخبار
القائمة -
-
 10:56 | 2022-6-12
10:56 | 2022-6-12
مهدي بوجمعة في حوار مع "الهدّاف": "أنتظر جوازي الجزائري واختياري اللعب للجزائر كان واضحا دائما"
-
 14:15 | 2021-2-21
14:15 | 2021-2-21
-
 12:42 | 2021-1-09
12:42 | 2021-1-09
آخر الأخبار
القائمة -
-
-

الهداف
ميسي يعبد طريق خروج بوكيتينيو من باريس -

الهداف
ميسي يبرئ لابورتا ! -

الهداف
ميسي يرتاح ويريح برشلونة
آخر الأخبار
القائمة -
-
آخر الأخبار
القائمة
“دعُوها فإنها مُنْتِنة”
ساد التاريخ المنقبي ـ المَناقِب ـ في العهد الزيّاني والتّركي مثل هيمنة نص ابن مريم “البُستان” وسِير بعض الأولياء والفقهاء كأحمد بن يوسف الملياني والمغيلي والهوّاري...
وبرزت الكتابة المنقبية في فترات مقاومة الاحتلال فيها عنصر الجهاد كحَاجة للتّعبِئة، واستمرّت منهجية المزج بين ما هو حقيقي وخيالي عندنا بعد الاستقلال من خلال بعض مذكّرات المجاهدين أو سِير الشّهداء، أي الحاجة إلى ربط الأجيال بالآباء والأجداد وحماية قيم “الوطنية” في مواجهة ثقافة النّسيان. إذن “الحاجة للعودة إلى العصر الذّهبي الأوّل للإسلام أو الخوف من انهيار القيَم الموروثة الحافظة للأمّة أو البحث عن التّعبئة للجهاد وبعث الوطنية والإرادة في شخصية المواطن، هي عوامل قوّة حضور الخيال وطابع القَداسة في نصوص التاريخ المنقبي - سير وتراجم العلماء والأولياء والمجاهدين -، هذا على مستوى الكتابة والذّاكرة الشّعبية، ولكن هناك ظاهرة أخرى أكثر ضررًا ليس من النّاحية العلمية فقط ولكن تلحق ضررًا بالشّخص الميّت المُحتفى به، إذ تحوّلت أسماء جزائرية تاريخية إلى أسماء عائلية محلية. فظاهرة تأسيس مؤسّسات وجمعيات باسم الشّخصيات الوطنية والعلمية كانت منذ البداية خيانة للّذين يَتكلمون باسمه، فهو تراث للجميع ومِلك عام ولكنّه يُتملّك عائليًا أو من قبل مجموعات انتهازية مصلحية، فحين يصير مثلاً الأمير عبد القادر ملكا للّذين يحملون التّقاييد النّسبية “شجرات النّسب” أو من الجهة الجغرافية نكون أمام شخصية محلية وعائلية وهو في الأصل شخصية إنسانية أو مثل مولود قاسم نايت بلقاسم حين يكون الانتماء إليه بالعِرق والجهة يكون ذلك أخطر على أفقه الإنساني ووطنيته، هذا التّقزيم من العالمية والوطنية إلى العائلة أو الدشرة أو العِرق والجهة هي ما كان يقصده الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: “دَعوها فإنّها مُنتِنة” -جاهلية الافتخار بالعِرق والجهة -، ومثل ذلك الّذين حاولوا أن يجعلوا من فكر مالك بن نبي يَخصّ اتّجاهًا محدّدًا، أو كالّذين يبحثون عن مرجعية في الجزائر يفتقدونها بالعودة إلى الشّيخ ابن باديس، ويشترك مع هؤلاء في “النّتانة” سَعْي كلّ جهة أو ولاية في التحدّث عن علمائهم بقداسة تتجاوز الحقائق التاريخية، ويمكنكم معرفة الضّرر الّذي لحق متصوّفة وأولياء معروفين حين وَرِث طريقتهم الأبناء واعتبروا الميراث الرّوحي ضمن الميراث المادّي في حين أنّه مفتوح للّذي سلك الطّريقة مهما كان جنسه ولونه وجهته.
-
 16:30- 2021/09/22
16:30- 2021/09/22 -
 16:20- 2021/09/22
16:20- 2021/09/22 -
 14:07- 2021/09/21
14:07- 2021/09/21 -
 13:56- 2021/09/21
13:56- 2021/09/21 -
 13:33- 2021/09/21
13:33- 2021/09/21 -
 20:18- 2021/08/30
20:18- 2021/08/30 -
 15:39- 2021/08/15
15:39- 2021/08/15 -
 13:40- 2021/08/15
13:40- 2021/08/15 -
 13:16- 2021/08/15
13:16- 2021/08/15 -
 13:15- 2021/08/15
13:15- 2021/08/15 -
 12:56- 2021/08/15
12:56- 2021/08/15 -
 12:47- 2021/08/15
12:47- 2021/08/15 -
 12:43- 2021/08/15
12:43- 2021/08/15 -
 12:54- 2021/08/09
12:54- 2021/08/09 -
 12:48- 2021/08/09
12:48- 2021/08/09 -
 15:10- 2021/08/04
15:10- 2021/08/04اجتماع حاسم لإدارة ميلان مع نظيرتها من الريال للفصل في صفقة إيسكو
-
 14:50- 2021/08/04
14:50- 2021/08/04 -
 14:42- 2021/07/27
14:42- 2021/07/27 -
 18:30- 2021/07/25
18:30- 2021/07/25 -
 18:10- 2021/07/25
18:10- 2021/07/25
-

كريستيانو كاد يصاب على مستوى كتفه بسبب سيلفي
-

بن زيمة ... كرم كروي قابله لإنتقام عرقي .
-

احتفال السفارة السعودية في الجزائر بالعيد الوطني للمملكة
-

فيديو الإعلان الرسمي عن شعار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022
-

ملال يمثل أمام لجنة الانضباط ويؤكد ثقته في إلغاء العقوبات
-

برناوي يوضح بخصوص قضية اتحاد العاصمة و يؤكد استقباله لملال
-

الهداف تزور مسقط رأس الناخب الوطني بلماضي عين تدلس بمستغانم
-

يونس إفتسان مدرب جديد لاتحاد بلعباس
الملفات
القائمة 12:00 | 2021-08-01
أديبايور... نجم دفعته عائلته للانتحار بسبب الأموال
12:00 | 2021-08-01
أديبايور... نجم دفعته عائلته للانتحار بسبب الأموال
اسمه الكامل، شيي إيمانويل أديبايور، ولد النجم الطوغولي في 26 فيفري عام 1984 في لومي عاصمة التوغو، النجم الأسمراني وأحد أفضل اللاعبين الأفارقة بدأ مسيرته الكروية مع نادي ميتز الفرنسي عام 2001 ...
 07:57 | 2020-11-24
إنفانتينو... رجل القانون الذي يتسيد عرش "الفيفا"
07:57 | 2020-11-24
إنفانتينو... رجل القانون الذي يتسيد عرش "الفيفا"
يأتي الاعتقاد وللوهلة الأولى عند الحديث عن السيرة الذاتية لنجم كرة القدم حياته كلاعب كرة قدم فقط...
 23:17 | 2019-09-13
يورغن كلوب... حلم بأن يكون طبيبا فوجد نفسه في عالم التدريب
23:17 | 2019-09-13
يورغن كلوب... حلم بأن يكون طبيبا فوجد نفسه في عالم التدريب
نجح يورغن كلوب المدرب الحالي لـ ليفربول في شق طريقه نحو منصة أفضل المدربين في العالم بفضل العمل الكبير الذي قام مع بوروسيا دورتموند الذي قاده للتتويج بلقب البوندسليغا والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما أوصله لتدريب فريقه بحجم "الريدز"...
الأرشيف PDF
النوع
- طبعة الشرق
- طبعة الوسط
- طبعة الغرب
- الطبعة الفرنسية
- الطبعة الدولية
السنة
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2006
- 2003
- 0
الشهر
اليوم









 “دعُوها فإنها مُنْتِنة”
“دعُوها فإنها مُنْتِنة”